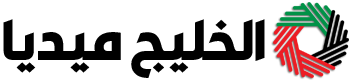يرى ضيفنا أنّ الربع الأخير من القرن الماضي في اليمن كان من أخصب المراحل، وأنّ وعيه الأدبي تشكّل في بيئة مستقرة؛ في أسرة علمية كان جدّه لأبيه فيها علاّمة وشخصية علمية واجتماعية مبجَّلة.
نشأ ضيفنا في «الحيمة الخارجية» التي يصفها بأنها ذات طبيعة ريفية نقية، وهدوء ساحر، ويعيد ضيفنا الفضل في تشكُّل وعيه الأدبي والثقافي إلى التربية والتعليم والكتب الدينية والأدبية، وخبرات المدرسين المصريين في التعليم العام، إضافة إلى أثر جامعة صنعاء في بداية التسعينيات بإدارة رئيسها الأكاديمي والشاعر الدكتور عبدالعزيز المقالح التي كان لها أثر كبير عليه، فقد كانت وجهة لكبار الأكاديميين من الوطن العربي، وللأسماء الكبيرة التي درّسَت فيها. الكثير من الموضوعات والقضايا نفتحها في هذا الحوار مع ضيف «عكاظ» الدكتور إبراهيم أبو طالب.. فإلى التفاصيل:
• نود أن نبدأ من البدايات، كيف تشكّل الوعي الثقافي والأدبي عند إبراهيم أبو طالب؟
•• من خلال البيئة التي عشتُ تفاصيلها في اليمن، ومرحلة الاستقرار أثناء الربع الأخير من القرن الماضي كانت مرحلة خصبة لليمن، فبدأ تشكُّلي في بيئة مستقرة نسبياً، في إطار أسرة علمية عميدها الجد العلامة عبدالرحمن أبو طالب (رحمه الله)، وكان شخصية علمية واجتماعية مبجَّلة في الحيمة الخارجية، ذات الطبيعة الريفية النقية، والهدوء الساحر، فكان للجدّ أثر كبير في زرع الكثير من القيم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، المباشرة في الإشراف على التعليم، والمتابعة الدقيقة، وغير المباشرة في تمثُّل القدوة والأنموذج في شخصية مهابة جليلة لا يغادر الكتاب تفاصيل حياته اليومية ومكتبته العامرة بالكثير من الكتب الدينية والأدبية، ثم نظرة المجتمع لشخصيته، والانتفاع بعلمه، إذ كان مجلسه اليومي لا يخلو من أصحاب الحاجات من مُستفتٍ أو صاحب قضية يريد حلَّها، أو زائر يريد الاستزادة من علمه وأدبه، ثم يأتي دور المدرسة فقد كانت تضمُّ عدداً من الأساتذة المصريين، وكلُّهم من أصحاب الخبرة الطويلة في التدريس ممن اشتغل لما لا يقل عن عقدين من الزمان في تخصُّصه، ولهذا كان لهم فضلٌ لا يُنكر في تشكيل الوعي العلمي بحسب المرحلة العمرية، ثم كانت جامعة صنعاء مصدر إشعاع حضاري في بداية التسعينيات، بإدارة رئيسها الأكاديمي والشاعر و«البوابة الثامنة» لصنعاء كما أسميه أستاذنا عبدالعزيز المقالح، وكانت وجهة لكبار الأكاديميين من الوطن العربي، وللأسماء الكبيرة التي قامت بالتدريس فيها، وهم كثرٌ وقد أفردتُ لهم حديثا طويلاً في كتابي (من هؤلاء تعلَّمت: سيرة ذاتغيرية). فكان للجميع أثرٌ كبير في تشكيل الوعي المعرفي والثقافي والجمالي.
• ما الأثر الذي أحدثه أستاذك عبدالمنعم تليمة في حياتك؟
•• هو مدرسة أخرى على المستويين الإنساني والمعرفي، فعلى المستوى الإنساني كان أنموذجاً رائعاً للأستاذ المتواضع، وللمثقف المفكر، وعلى المستوى المعرفي كان لكتابيه: (مقدمة في نظرية الأدب) 1973، ذلك الكتاب الذي لا تكاد تخلو رسالة من الاستعانة به، والإشارة إلى بعض فقراته، وكذا كتابه (مدخل إلى علم الجمال الأدبي) 1978، إضافة إلى العديد من المقالات المهمّة والمقدمات الدقيقة كما في تقديمه للطبعة الأخيرة من كتاب (طه حسين في الشعر الجاهلي)، والعشرات من اللقاءات والحوارات والمقالات كلّها قرأتُها، وتمثّل طريقتَه في الكتابة، تلك الطريقة السهلة الممتنعة، والدقيقة الموجزة، فهو تلميذٌ للمدرسة المصرية العريقة التي منها سهير القلماوي، وأمين الخولي، وكان يسميهما شيخيَّ الجليلين غير مفرِّق بينهما في الإجلال سوى إجلاله الأكبر لأستاذه (طه حسين).
وتأثرتُ كثيراً واستفدتُ من مجلسه العامر، وصالونه الأسبوعي كلَّ خميس، في ذلك المجلس تعلمتُ ما لم أقرأه في كتابٍ، ولا يمكن أن أحصل عليه في مدوَّنة، وكان التنزّه في عقول الناس من مبدعين ومفكرين وأدباء وكتاب وفنانين وأكاديميين من مصر ومن الوطن العربي كان لنا بهم لقاء، وللحوار معهم فائدة، والاستماع إليهم مدرسة فكرية وعلمية وأدبية، في بساطةِ طرحٍ، مع الانضباط الشديد في المداخلات، إذ كانت طريقة أستاذنا المتَّبعة هي بدء الحديث في المجال الذي سيدور حوله النقاش من خلال الضيف، وكان لا يعدم في كل مرة أن يأتي بضيف من الوطن العربي يجعل وجهته الثقافية (صالون تليمة الأسبوعي)، فكان يتحدث أستاذنا عن الضيف أولاً، ثم يترك له الحديث بحرية كاملة، ثم تأتي المداخلات وإشباع الموضوع المطروح في تلك الأمسية، وإن لم يكن هناك ضيف، فإمَّا كتاب جديد صدر، أو مقال رأي مهم، أو حدث سياسي أو اجتماعي يكون مدار اللقاء، وأما الفنُّ فكان في لقاءات قليلة، إذ استمعنا مرة لمؤلفات الفنان العراقي نصير شمَّة، ومرة أخرى للموسيقار اليمني أحمد فتحي، وقد أكرمني بالحضور بعد مناقشتي للدكتوراه، وما تعلمناه من أساليب الحوار، واحترام الرأي، وطرح وجهات النظر كان هو زبدة ما يمكن أن يفتح الآفاق للمعرفة، وللاطلاع على الكثير من التجارب وتقبُّل الآخر أيّاً كان نوعه أو جنسه، وبالمناسبة فقد أجمعَ الجميع من الشخصيات التي كانت على اختلاف توجهاتها ما بين يسار ويمين، ووسط، على محبَّته واحترامه، وهو يرحب بهم بكل تقدير واحترام، وكان صنيعه ذلك هو ما يسع الجميع.
• علاقتك بالببليوغرافيا.. كيف بدأت؟ وإلامَ انتهت؟
•• علاقتي بالببليوغرافيا كان سببها ودافعها الأوَّل الاحتياج، إذ كنتُ في القاهرة مطلع الألفية، وأردتُ أن أسجِّل موضوعاً للماجستير في جامعة القاهرة، فلم أجد ما يدلّني على الدراسات السابقة -ولم يكن الأمر مثل اليوم من خلال البحث في منصات وغيرها- فبدأت في الاطلاع على ما سبق دراسته لأختار موضوعاً جديداً للدراسة، فما وجدتُ من أدبيات في مكتبات الجامعات سوى الببليوغرافيا عن الرواية العربية التي أعدها الدكتور حمدي السكوت، ووجدت أن ما رصده عن اليمن والروايات أو القصة عموماً قليل جداً، والسبب عدم وصول الإصدارات وانتشارها، أضفْ إلى ذلك طبيعة الشمولية التي سعى إليها مشروعه، ووجدت اليمن أقلها حضوراً وبيانات، فبدأتْ فكرة الجمع والتوثيق للببليوغرافيا في ما أنا بصدده، وهو السرد، فجمعتُ ما استطعتُ جمعه، ثم صار الأمر هاجساً ملحّاً في ملاحقة كل ما يخصُّ اليمن في مجال السرد إبداعاً ونقداً، واستمر الجمعُ والبحث، وحين سافرتُ لجمع المادة العلمية من اليمن زرتُ الكثير من المكتبات في صنعاء وفي عدن، فكانت حصيلتها الكثير من البيانات عن القصص المنشورة في المجلات والدوريات، وكذا الجانب النقدي، وبعد أن أنجزتُ رسالتي للدكتوراه ألحقتُ بها ببليوغرافيا عن القصة، ومن قبلها في الماجستير ببليوغرافيا عن الرواية، ثم طورتُها، وفصلتها عن الرسالتين وأضفتُ إليها ببليوغرافيا عن الأدب الموجَّه للطفل إبداعاً ونقداً، وصدر في كتاب عام 2010، ثم تابعتُ الإصدارات بعد ذلك، واستعنتُ بالإنترنت والمنصات والمجلات وغيرها فطورتُ المشروع حتى صار في ثلاثة أجزاء مستوفياً مسيرة الرواية والقصة القصيرة والقصيرة جداً وأدب الطفل في اليمن خلال قرن من الزمان تقريباً، وصدرت موسوعة ببليوغرافيا الأدب اليمني عن دار عناوين Books في القاهرة، عام 2022، في أكثر من 1100 صفحة.
تلك هي حكايتي مع الببليوغرافيا التي بدأتِ احتياجاً للمعرفة، واستمرت شغفاً في الجمع والتوثيق والرصد، وانتهت مسؤولية في عرض ذلك كله للباحثين والمهتمين لمعرفة مسيرة السرد في اليمن خلال قرن من الزمن تقريباً.
• لديك رحلة في أدب الطفل.. حدثنا عنها.
•• نعم، بدأتُ في الكتابة للأطفال منذ تخرجت من الجامعة، إذ كنتُ معلِّماً للغة العربية في (ثانوية عمَّار بن ياسر) في صنعاء، ومشرفاً على النشاط الطلابي الصَّباحي، ومتابعة طابور الصباح، فوجدت الكثير من المواهب لدى طلاب المدرسة، وقمنا بنشاط مدرسي سُمِّي (اليوم المفتوح)، فكتبتُ أوبريتاً لذلك اليوم المفتوح، لحَّنه زميلٌ لنا اسمه طارق السعدي (فلسطيني الجنسية) كان يعمل في المدرسة، ثم عُرض أمام وزير التربية حينها (الدكتور أبو بكر القربي) وعدد من المسؤولين، فنال الاستحسان، وطلب منَّا التلفزيون تسجيله في برنامج (جيل الغد)، وتم بثُّه، فشكَّل ذلك دافعاً مؤثراً، ثم شاركنا مع الطاقم ذاته في مهرجان المسرح المدرسي الأول لأمانة العاصمة، وفازت مسرحيتنا (إنا نحن من يهواكِ) عام 1995 من إخراج العراقي علي نجم جدّوع بالمرتبة الثالثة على مستوى الأمانة، وبشهادة شكر وتقدير، ثم بدأتُ أدركُ أهمية هذا الميدان، ومدى الفراغ النسبي فيه، فحين كان الإعلان عن الاحتياج لنصوص لمسابقة رمضان للأطفال في إذاعة صنعاء، في عام 1997، قررتُ خوض التجربة، فتقدَّمتُ بمقترح لخمس حلقات، بعنوان (عالم المعرفة) يحتوي على حكايات وأناشيد، فقُبلتْ، وأكملتُ 30 حلقة، أنتجتها الإذاعة في شهر رمضان، من إخراج طاهر الحرازي، ومثَّلت فيها المذيعة المتألقة مها البريهي، ومثَّل معها الكثير من فناني المسرح الوطني على رأسهم المبدع نبيل حزام وآخرون، ولحَّن أغانيها الفنان فؤاد الشرجبي، ولاقت نجاحاً كبيراً وصدى مؤثراً، فكانت دافعاً آخر للاستمرار، وبالفعل في العام التالي تعاقدت معي الإذاعة في عمل جديد لمسابقة الأطفال لشهر رمضان، بعنوان (حكايات) في 30 حلقة مسجلة، قُدِّمت في حلقات مسلسلة في إذاعة صنعاء، من إخراج سمير المذحجي، عام 1998.
ثم حين انتقلتُ إلى القاهرة للدراسات العليا مع نهاية عام 1999 وبداية الألفية الثالثة، وجدتُ في معرض الكتاب بالقاهرة الكثير من دور النشر المتخصِّصة في الأدب الموجَّه للطفل، فتواصلتُ مع إحداها، وهي شركة مكة للبرمجيات، وكانت نتيجة ذلك عدداً من الأعمال؛ أهمها: (أناشيد الطفولة) في مجسمات، ولحنت بعد ذلك في أشرطة وسيديهات بعنوان (عصفورتي المغردة)، و(أدواتي المدرسية)، ثم كتبتُ للشركة (قصص الأنبياء: حكايات وأناشيد)، وقد أُخرجت تلك الأعمال جميعها بأكثر من وسيلة وطريقة ابتداءً بالمجسمات، ثم أشرطة الكاسيت، ثم الأقراص المدمجة (CD) ثم أخيراً على القنوات الفضائية ملحنة ومؤدَّاة بأصوات أطفال الأوبرا المصرية، وأدائهم الجميل، ومن ألحان أحمد رمضان، وصار لها رواج وتناقل في الكثير من القنوات الفضائية، ولم تقف التجربة عند ذلك فقد استمرَّت الكتابة، وأخرجتُ عدداً من الأعمال الشعرية، منها: ديوان (أنا أحبُّ عملي) صدر عن (مجلة العربي الصغير) في الكويت عام 2013، وديوان (هيا نغنِّي يا صغار) عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة عام 2013، ثم ديوان (أغاريد وأناشيد للبراءة) عن نادي أبها الأدبي عام 2016، وهو الديوان الذي كان أصلُه فائزاً بجائزة السعيد الثقافية في اليمن سنة 2004، في مجال أدب الطفل، وبه حقَّق ذلك الديوان وصاحبُه الريادة في أدب الأطفال في اليمن، بوصفه أوَّل ديوان يكون موجّهاً للطفل وخاصّاً به، ثم أخيراً صدر ديوان (وطني العربي: 22 سنبلة في بستان واحد)، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (سنابل)، عام 2022.
وبالنسبة للنقد والدراسات الخاصَّة بالأدب الموجه للأطفال فقد سار الاهتمامُ به متوازياً مع الكتابة الإبداعية؛ إذ صدرت في هذا الحقل الكتب الآتية: (النص والبراءة، قراءات في الأدب الموجة للطفل)، صادر عن نادي المدينة المنورة الأدبي، ودار سطور عربية، جدة، 2021، وكتاب (تحولات اللغة وفاعلية التقنيَّة في إنتاج المعنى.. دراسة في الأدب الموجه للطفل)، مشترك مع الأستاذ الدكتور عبدالحميد الحسامي، والدكتور فوزي صويلح، صادر عن مركز التميز البحثي في اللغة العربية، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، 2020، وكتاب (حَجَرَه بَجَره.. مقاربات في الأدب الموجه للطفل)، صادر عن دار ديوان العرب، بورسعيد، ط، 1، 2025.
• هل لدينا مفهوم خاطئ للنقد؟
•• هو ليس مفهوماً خاطئاً بقدر ما هو ممارسة للنقد غير صائبة، والنقدُ في تصوري يمكن أن نقسِّمه إلى ثلاثة أنواع: نقد أكاديمي منهجي مدرسي بمعنى أنَّه يخضع للمناهج النقدية، ويلتزمها حرفياً، ويسير في مفاهيمها المهيمنة ومداراتها ورموزها الصَّارمة، وفي لغتها النخبوية التي تكاد تفصله عن الأدب، وتحوِّله في بعض الأحيان إلى رموزٍ لا يفقهها إلا الراسخون، وقليلٌ ما هم! والنقد الثاني: نقد يوازي الإبداع ويسيرُ في مداره موضحاً أو دالاً على مواطن الجمال فيه وجوانب القصور، ولا يخلو من منهج، ولكنَّه لا يشرِّح الوردةَ إلى عناصرها الأولية، بل يعيد التأمل فيها، ويقرأ جمالها من زوايا عدَّة لا تُفقِدها روحها، وإنما تضيف إليها روحاً أخرى، هي روحُ الناقد وخبرته، وزوايا نظره الحادة والثاقبة ذات الأفق الأوسع التي تساعد على فهمه، وما كان للنص أن يصل إلى مستواه اللائق إلا بها. والنوع الأخير: هو النقد الانطباعي الترحيبي الصحفي القائم في أغلبه على «الترندات» -إن جاز التوصيف بلغة الإعلام الجديد- إذ يقوم على موجة الترويج للشائع أصلاً، ويعتمد عليها أو يساير مَن قد حقَّق وصولاً نوعيّاً أو جماهيريّاً معيناً.
ولهذا فعلى الناقد الحقيقي أن يكون قبل كلِّ قراءةٍ مثقفاً كبيراً، ومبدعاً متذوقاً في ما يقوم بنقده، وليس بالضرورة أن ينتج نصوصاً أدبية، ولكن بالضرورة أن ينتج نقداً جماليّاً وفكراً ورؤية، ولهذا سيظلُّ الناقد الكبير والقارئ الحقيقي مثل الإبريز الأصفر أو كالذهب المصفَّى يحتاج إلى الكثير من الوقت والتجربة والثقافة والقراءة ليحقِّق حضوره النوعي وصوته الخاص.
• ماذا عن الأدب في اليمن قديماً وحديثاً؟
•• الأدبُ في اليمن قديماً حاضرٌ بقوَّة على كل المستويات، وقد لخَّص وجوده وحضوره قديماً وحتى تاريخه أبو عمر بن العلاء (ت.154هـ) بقوله: «كادتِ اليمنُ أن تذهب بالشعر كلِّه» إذ كان الشعرُ ديوانُ العرب. ولا يخفَى ما لكتاب (التيجان في ملوك حمير) لوهب بن منبِّه و(كتاب الملوك وأخبار الماضين) لعبيد بن شرية، وغيرهما، من حضور على مستوى التأسيس السَّردي والتاريخي. وقد رافق الأدب الإنسان في كل مراحله حتَّى شكَّل تراثاً كبيراً، وأمَّا عن الأدب حديثاً، فهو حاضرٌ في مفاصل المجتمع اليمني بتقلباته الكثيرة وآلامه وآماله المتعددة، وسط ما يعانيه من واقع مرٍّ وتقلبات مريرة، لكنَّه يظل هو الصوت الأنقى والمعبِّر الأرقى، ومن أراد أن يتعرَّف على اليمن فلديه نافذتان: طبيعته الساحرة وأدبه الحقيقي الذي يكتبه إنسانه البسيط بعيداً عن السياسة ووجع القلب.
• في عام 1999 كان للدكتور إبراهيم أبو طالب رأي في قصيدة «النثر» وأنها لا تنتمي لـ«القصيدة» وكما قلتَ في وقتها: يجب علينا ألّا ندرجها ضمن دائرة «الشعر»، لكنك عدت في 2015 لتقول إنها «قصيدة» مدهشة ورائعة! ما الذي تغيّر؟
•• الوعي بالأنواع والقراءة في الأشكال الأدبية وآفاقها هو الذي تغيَّر، ربما ظهر في الحكم السابق نزقُ الشباب واندفاعُ الرغبة في الكتابة والقناعة بما أكتب حينها وما أقرأ، كذلك دور المحيط الذي كان يُعلِي من شعر التفعيلة عند جيل التسعينيات أو شعر العمود عند من قبلهم، أمثال الأساتذة: البردوني، والشامي، والحضراني، والموشكي، والزبيري، والمقالح… والقائمة تطول ممن شكَّل لدينا ذائقة الشعر وجمالياته، وشكله، كما أن أكثر الأصوات القادمة في جيلنا التسعيني كانت من ثقافة تراثية، وقراءة نموذجية، ذلك أمرٌ، والأمر الآخر هو عدم وجود النماذج المميَّزة في تجارب الشباب حينها، وعدم وجود الصوت الأقوى أو الأبرز في كتَّابها.
ولكن ربما مع قراءاتي اللاحقة في التجارب العربية الناضجة أمثال تجربة محمد الماغوط، وأدونيس، وأنسي الحاج، ومحمود درويش، وسليم بركات، وحلمي سالم، وغيرهم، وكذا التجارب اليمنية الجديدة الشابة التي استوعبت فكرة النثرية وطبيعة اعتمادها على الصورة التي تُغني عمَّا فقدته من إيقاع، وخصوصاًعند من يجرِّبها بعد أن خاض الكثير من المحاولات الناجحة -إلى حد كبير- في القصيدة الموزونة، وإن كانت القصيدة النثرية ليست ذات حضور كبير كما حققته «ق ق ج» مثلاً أو بقية أنواع القصيدة اليوم، لكن تظل محاولة من حقِّها المنافسة والعيش والدفاع عن نفسها، ليس بالإعلام أو التكتلات الشللية النوعية، ولكن بما يحقق حضورها الفني والجمالي، وفكرتها وفلسفتها الخاصّة التي تنبعُ من المجتمع العربي وتعود إليه، وليس من خلال الاستزراع أو الانبهار بالغريب، ومحاولة التجريب فقط، ولذلك أظن أنَّ أي نوع أدبي من حقِّه، ومن حقِّ مبدعيه ومتابعيه مراجعته، ومساءلته، وتأمّله، والحكم عليه، ولكن يجب أن يكون ذلك الحكم بمعايير نقدية وموضوعية ومنهجية مُنْصفة.
• هل تجارب قصيدة النثر العربية ما زالت كما تَرَى مخاضاً؟
•• عند بعض الشباب المتعجِّل الذي لا يشتغلُ على موهبته تنمية وتجويداً ورعاية هي كذلك، ولكن مَن يُخلص لها، ويوقفُ تجربته بكلِّ أبعادها للعناية بفهمها أولاً، ثم بإبداعها وفق شروطها ثانياً سيصلُ، وربما يُنافس، ولكن من يأخذها دون قوَّة، تظلُّ مثل غيرها تجارب مخاضيَّة، ولمَّا نجد المبدع الحقيقي، وليس ببعيد عنَّا أنَّ من يُخلص لأيِّ نوع، ويعطيه كلَّ حياته ربما يعطيه ذلك النوع جزءاً من الخلود الحقيقي، ألا نتأمل في تجارب المبدعين العرب من حولنا، ممَّن يسيرُ لعقود طويلة يكتب ويكتب لهذا وصل، وأمَّا من يأتي ببيضة الديك، فذلك يكون أثرُه عابراً، وعمله غابراً.
• لماذا كُتّاب اليمن، اليوم، يفضّلون كتابة الرواية على القصة؟
•• ربما لأنَّ الرواية صوتُ المجتمع والأكثر تعبيراً عنه وعن مشاكله وقضاياه وظروفه ومتغيراته أكثر من صوت القصة المجبولة على أنها صوتُ الفرد، ولهذا فهو كالشعر يعبِّر في الغالب عن قضايا جزئية وغنائية (ذاتية)، في حين الرواية تستوعب ذلك الكم الكبير من التناقضات والصراعات، وما يمرُّ به اليمنُ أكبر من أن تعبِّر عنه القصيدة أو القصة -مع أنهما تفعلان، وتكافحان في التعبير- ولكن السعة التي تمتلكها الرواية، والحرية، والتجريب الذي يتيح لكلِّ صاحب تجربة خاصَّة أو مقدرة على التعبير أن يخوض غمارها، ويدلي بدلوه، ولكن البعض من تلك الروايات قد نجح، والبعض الآخر ظل محاولات في الكتابة السّردية، ولهذا فقد تعدَّدت الروايات، وكثرت من حيث الكم، وربما أتاحت لها المطابع -بحسب الموضة السَّارية- الكثير من الفرص، أضف إلى ذلك الجوائز المغرية لكتَّاب الرواية، وعلى العموم فإن الرواية في اليمن تعيشُ أخصب مراحلها النوعية والكمية.
• علاقتك بالأدب في السعودية، كيف تقرأها بعد سنوات من العمل أكاديمياً في جامعة الملك خالد، ومشاركتك في العديد من الفعاليات الثقافية داخل مؤسسات الثقافة السعودية؟
•• هي علاقة قراءة مستمرَّة ومتابعة للمشهد الأدبي في عسير خصوصاً وفي المملكة عموماً، قامت تلك العلاقة بدءاً من الاطلاع والتأمل لمعرفة طبيعة ذلك الأدب وأعلامه ومستوياته، وأثمرت تلك القراءة عدداً من الأبحاث والمقاربات والدراسات التي نُشرت خلال السنوات العشر الماضية، في كتب ومجلات علمية محكّمة، وملتقيات.
ثم من خلال التوجيه لطلاب الدراسات العليا بدراسة الأعمال والأعلام في الأدب السعودي عموماً والعسيري خصوصاً، وقد أنتجتْ تلك العلاقة -كذلك- عدداً من الأطروحات المتميِّزة والكثيرة التي صدر أغلبها في كُتبٍ، ورفدت المشهد النقدي في المملكة، ذلك المشهد المتنوّع والثري بالكثير من الإبداع في مجالات القول المختلفة شعراً، وسرداً، ومقالة، وسيرة، ورحلة، وفي ظنِّي أن الرواية في السعودية الآنَ هي من يحقِّق حضوراً لافتاً على المستوى الإبداعي، وعلى المستوى النقدي معاً، وقد قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، ولكنَّها لا تزال بحاجة إلى أن تخرج للمنابر العالمية من خلال حركة ترجمة مؤسسية مقصودة.
أخبار ذات صلة