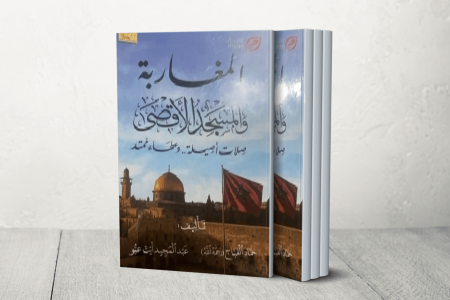في قلب القارة الأفريقية، حيث تتنفس السافانا أنفاس الأسلاف، كانت روديسيا، الدولة الحبيسة، مسرحًا لصراع طويل بين الاستعمار والهوية.
سكنت شعوب السان هذه الأرض منذ آلاف السنين، قبل أن تصل موجات الهجرة البانتوية، حاملةً معها لغات وأساطير ومعتقدات روحية.
مع نهاية القرن التاسع عشر، دشّنت شركة جنوب أفريقيا البريطانية مرحلة الاستعمار في روديسيا الجنوبية، لتخضع البلاد لحكم الأقلية البيضاء من المستوطنين الأوروبيين.
وفي عام 1965، أعلن رئيس الوزراء إيان سميث استقلالًا أحاديًا عن بريطانيا، ما أدى إلى عزلة دولية وحرب تحرير قادتها حركتا زانو بقيادة روبرت موغابي، وزابو بقيادة جوشوا نكومو.
تحت ضغط الحرب والعقوبات، دخلت روديسيا مفاوضات لانكستر هاوس عام 1979، التي مهدت لأول انتخابات ديمقراطية. وفي 18 أبريل/نيسان 1980، وُلدت زيمبابوي، معلنةً نهاية الاستعمار وبداية عهد جديد.
تضم زيمبابوي 16 لغة رسمية، أبرزها الشونا التي يتحدث بها أكثر من 70% من السكان، بينما تُستخدم الإنجليزية لغة مشتركة في الحكومة والتعليم، وهي اللغة الأولى للبيض والثانية لغالبية السود.
موسيقى حرب الأدغال.. حين يصبح الإيقاع سلاحًا
قبل أن تتحول الموسيقى إلى سلاحٍ في يد الثوار، كانت مرآةً للروح الزيمبابوية. تقليديًا، ترتكز على السلم الخماسي، مثل سلم “دو الكبير” (دو – مي – فا – صول – سي بيمول)، وأحيانًا على سلم خماسي صغير (دو بيمول – مي بيمول – فا – صول – سي).
كما تُغنى أنماط “المبيرا” على سلم سباعي يُشبه المقامات الأفريقية التقليدية، لكنه يختلف عن النظام النغمي الغربي المتساوي. تعتمد الموسيقى الزيمبابوية التقليدية في العموم على التكرار الميلودي، وتُرافقها إيقاعات الطبول التي تُشبه نبض الأرض.
الموسيقى إحدى أدوات التحرر
وفي خضم حرب تحرير زيمبابوي (1964-1979)، تحولت الموسيقى إلى أداة تعبئة وتحريض، تُغني للثورة وتُعلّم المقاتلين، وتبني الهوية الوطنية في وجه الاستعمار. كانت الأغاني تُردد في المعسكرات، وتُستخدم في التدريب، وتُغرس في الوجدان كأنها صلاةٌ يومية.
موسيقى “تشيمورينغا” كسرت الطوق الثقافي الاستعماري، وأصبحت أشبه بالطائفة الروحية لمقاتلي التحرر، بسبب نزوعها إلى الأصول الأفريقية.
استخدمت جماعات المقاومة الأغاني كأدوات تنظيمية، وفي أحيان كثيرة كجزء من إعداد المقاتلين، في مقابل الموسيقى الوطنية للأقلية البيضاء التي احتفظت بسيطرة رمزية تراجعت لاحقًا أمام زخم موسيقى المقاومة.

توماس مابفومو.. صوت الثورة الذي لا يُسكت
في خضم هذا الزخم، بزغ نجم توماس مابفومو، الموسيقي الزيمبابوي الذي يُلقب بـ”أسد زيمبابوي”، و”موكانيا” بلغة قبيلته. ابتكر مابفومو نمطًا موسيقيًا جديدًا أطلق عليه اسم “تشيمورينغا”، وهي كلمة في لغة الشونا تعني “التحرير”، وتعود إلى اسم أحد قادة انتفاضة 1896، مورينغا، الذي أصبح رمزًا لحروب التحرير.
مزج مابفومو بين موسيقى الشونا التقليدية وآلة “المبيرا”، وبين الآلات الكهربائية الحديثة، ليخلق صوتًا ثوريًا يحمل مضامين اجتماعية وسياسية، ويدعو صراحةً إلى الإطاحة بالحكومة، كما في أغنيته “هوكويو!” التي تعني “انتبه!”، والتي تقول:
احذروا… احذروا !!
ها هو السيفُ بيدي،
ها هو الحدُّ عندي،
أنا المقاتلُ الوحيد،
أنا كاريكوغا، أناديك أيها الملك
انظروا… ها هو السهم العاشر،
قد أسقط اثنين بضربةٍ واحدة،
من يكون ذاك القادم؟
من يجرؤ على التقدّم؟
احذروا… احذروا !!
كانت كلمات الأغنية نداء يقظة، وصيحة تحذير، ورمزًا للمقاومة المسلحة. حظرت الحكومة الروديسية بثها، واعتقلت مابفومو دون تهمة، لكن الأغنية تسللت إلى الحانات ومحطات الإذاعة الحرة، ومنها “صوت موزمبيق”، لتصبح صوتًا لا يُقمع.
رقصة “توّي توّي”.. جسد يحتج
في معسكرات التدريب الجزائرية في ستينيات القرن الماضي، وُلدت رقصة “توّي توّي”، لا كفنٍ للترفيه، بل كتمرين عسكري للمجندين الأفارقة ثم انتقلت جنوبًا إلى تنزانيا وزامبيا، ثم إلى قوات تحرير زيمبابوي، لتصبح لاحقًا رقصة احتجاجية تُجسّد انتصار الروح على القمع.
كانت “توّي توّي” تُؤدى في الشوارع، وتُستخدم شكلا من أشكال العصيان المدني، حتى حصرها موغابي عام 2004 داخل القاعات، خشية أن تتحول إلى شرارة غضب، وكان نشيد “أماندلا” شعارًا شعبيًا حاشدًا، يُعتبر علامة مميزة للمؤتمر الوطني الأفريقي، و”أماندلا” تعني “القوة” في لغتي الزولو والهوسا.
بوب مارلي في هراري.. حين غنّى الريغي للحرية
في ديسمبر/كانون الأول 1979، وقّعت اتفاقية لانكستر هاوس في لندن، فاتحةً الطريق لأول انتخابات حرة في روديسيا، التي ستُعرف لاحقًا بزيمبابوي، وفي فبراير/شباط 1980، حقق حزب زانو-بي إف فوزًا ساحقًا، وأصبح زعيمه روبرت موغابي أول رئيس وزراء للبلاد.
بدعوة من قادة التحرير، سافر أسطورة الريغي الجامايكي بوب مارلي إلى هراري، حاملًا فرقته الموسيقية ونظامه الصوتي بالكامل، ليُشارك في حفل استقلال زيمبابوي في الأول من أبريل 1980، كان العرض مقررًا في ملعب “روفارو”، حيث امتلأت المدرجات بالجماهير، لكن الحدث تعطل بسبب تدفق الحشود نحو البوابات.
في تلك الأمسية، تحوّل الملعب إلى مسرحٍ للتاريخ. أُنزل علم بريطانيا، وارتفع علم الدولة الوليدة، وأشعل موغابي شعلة الحرية أمام أنظار العالم ووسط حضور بلغ 40 ألف شخص، يتقدمهم الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، ورئيسة وزراء الهند آنذاك إنديرا غاندي، اعتلى مارلي المسرح، ليغني لزيمبابوي.
لم يكن مارلي مجرد ضيف موسيقي، بل مؤمنًا إيمانا عميقًا بقضية التحرر الأفريقي. موّل رحلته بنفسه، وجاء ليشهد ميلاد أمة جديدة. ومع أول نغمة من أغنيته “زيمبابوي”، انفجر المدرج بالهتاف والدموع. بالنسبة للمحاربين القدامى، كان الصوت مزيجًا من النصر والحنين، وصرخةً في وجه الاستعمار.
كل إنسان له الحق في تقرير مصيره،
والحرية حقنا الطبيعي منذ مولدنا
نقول للفاسدين والطغاة:
وحدتنا هي قوتنا، وصمودنا هو طريقنا
زيمبابوي، إنه يومك،
يوم الحرية، يوم الكرامة، يوم الحياة
لكن أغنية “زيمبابوي” لم تولد في تلك الليلة فقط. قبل عامين، في أديس أبابا، بدأ مارلي بتجريب لحنها، مستلهمًا من روح أفريقيا وإيقاعات الشونا، كان يشعر أن لحظة الاستقلال قادمة، وأن صوته يجب أن يكون جزءًا منها. وهكذا تحوّلت موسيقاه إلى نشيد للمقاتلين، وصرخة في وجه الاستعمار والتمييز العنصري.
لم يخلُ الحفل من التوتر. آلاف تجمعوا خارج الملعب وحاولوا الدخول، ما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع، لكن مارلي لم يتوقف، ظل يغني وسط الدخان، ليجعل موسيقاه أقوى من الفوضى. وفي اليوم التالي، كرر العرض أمام جمهور مضاعف قارب المئة ألف، لتبقى تلك الليلة من أبريل/ نيسان 1980 محفورة في الذاكرة، ليلة غنّى فيها بوب مارلي لزيمبابوي، فصارت الأغنية وطنًا قبل أن يصبح الوطن حقيقة.